لا يمكن فصل الاحتياج الفلسطيني الأساسي للتعليم في حربه وصراعه مع الاحتلال على مدار الحياة، إذ يشكل التعليم لدى الفلسطيني حاجة مقاومة أساسية، ولا يراه مجرد حق تنصّ عليه المواثيق الدولية التي لم تُشكِّل عنصر حماية للفرد بالعموم خلال فترة الإبادة، فالتعليم بالنسبة للفلسطيني بالعموم والغزي بالخصوص هو معركة يومية يخوضها في وجه الاحتلال والحصار والدمار حيث تتراجع المؤسسات التعليمية مع كل عدوان أو تصعيد.
أما الآن فنحن أمام تعطُل كامل للمنظومة التعليمية بدءًا من اللحظة الأولى للحرب حيث إعلان الوزارة عن تعليق العمل بالمؤسسات التعليمية حتى إشعارٍ آخر، دون توفير بدائل عملية، وزاد الأمر سوءاً وتعقيداً حينما حاولت الوزارة العمل بنظام الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد. غير أنَّ مقومات هذا النظام لم تكن كافية لاستكمال مسيرة التعليم من انقطاع للكهرباء، وضعف شبكات الانترنت، وغياب البنية التحتية إذ أصبح التعليم في حُكم الميت أو شبه الميت من القرار الرسمي.
سارت المسيرة وفق جهود ذاتية من المعلمات أو الحاصلات على الشهادات أو الأمهات في البيوت. وهذا الفعل ليس الفعل الأول والأوحد فهي امتداد للجذور التاريخية الفلسطينية كفعل بقاء حيث إن العملية التعليمية على مدار الصراع تُواجه حالة من الإضرابات والإغلاقات للمؤسسات التعليمية، خاصة في ظلّ الانتفاضة الأولى (1987)حيث برزت العديد من المبادرات الذاتية التي تعتمد فيها الأمهات على خبراتها البسيطة في مواصلة التعليم، أذكر أنَّ أحد إخواني قال: "إننا لم نشهد هذا النزيف من الجهل في أشدّ أيام الإضرابات صعوبة أثناء الانتفاضة الأولى مع كل اضراب كنا نعود إلى البيت وتُجبرنا الأمهات على نسخ الدروس"، ويعزز بذلك فكرة ارتباط الطالب بشكل وثيق مع الكتاب المدرسي، ولا تقطعه عنه. إلا أننا الآن أمام نزيف لا يمكن تضميدّه في ظلّ هذا التغول من الاحتلال وتعمّده استهداف مسيرة العملية التعليمية عبر خلق ظروف غير مواتية ومناسبة لاستكمال العملية التعليمية.
قابلت سوزان _اسم مستعار_ في مساحة العمل حيث أتواجد كانت تشارك ابنتها الطالبة في المدرسة البريطانية بغزة في دروس كدورات تعليمية تطويرية تقول:
"عاد لي الأمل حين جددت المدرسة بناءها، واتخذت مقراً تعليمياً جديداً وبدأنا نتجهز للعودة للمدرسة بعد العيد مباشرة، لكنّ الحرب عادت قبل أن نعود للمدرسة مرة أخرى، وها نحن نحاول" (تقصد انتهاء الهدنة بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يومًا فقط -19 يناير حتى 18 مارس-) تمثل سوزان تجربة الأم الفلسطينية التي تحرص على تسليح أبنائها بالعلم والتعليم كسبيل تطويري لقدرّات الفرد وهي ليست التجربة الأولى في تاريخ الأمهات في مواجهة هذه الأزمات.
على سبورة في غرفة منزلية بمخيم الشاطئ كُتب عليها "الحرية أجمل" تُقدِّم من خلالها نادية حسونة، وهي معلمة للصفوف الأساسية بمدرسة القاهرة الأساسية، وحاصلة على ماجستير في المناهج وطرق التدريس مبادرتها التي لم تكن وليدة اللحظة؛ بل هي امتداد للمبادرة ذاتها التي بدأتها في منطقة السوارحة وسط القطاع -مكان نزوحها- تقول نادية:
"إنّ الدافع كان بشكل أساسي هي حالة التيه والضياع التي سببتها الحرب من خلال تعطيل العملية التعليمية كاملة بالإضافة إلى امتلاكي لأدوات ومهارات تؤهلني لأن أكون فاعلة في هذا المجال الذي يشكِّل حرصاً مني أنني على مدار 12 عاماً من الخبرة كنت حريصة على تأسيس الصفوف الأساسية التي ستشكِّل فيما بعد البنية الأساسية للعملية التعليمية، وإذا فقدها الطالب فإنّنا أمام ضياع كامل للفرد دون هذه المهارات.
أنشأت نادية بالإمكانيات البسيطة في أغسطس 2024 مساحة تعليمية من خلال شوادر بلاستيكية اعتمدت على توريدها بجهود العائلة وطوّعت مهاراتها التعليمية البسيطة لتُقدِّم الخدمة لمحيطها في مكان النزوح حيث تقول: "بدأت ألاحظ الحالة التي أصابت أبناء إخواني وأخواتي وغياب فكرة المدرسة عن أذهانهم، بل تجاوز الأمر أنّهم فقدوم رغبتهم بالتعليم ومواصلته" شكَّل هذا الأمر قلقاً بالنسبة لها فأرادت خلق هذه المساحة التعليمية من هذه الفئة بناءً على علاقاتها العائلية ومن ثم توّسَع الأمر لتستهدف آخرين من المنطقة _منطقة النزوح_ بمساعدة شباب عائلتها وبتنظيم الوقت وتسهيل تسجيل الطلاب للنقطة التعليمية. لم يكن الأمر بالنسبة لها سهلاً في البداية حيث شح كامل بالقرطاسية، بل وارتفاع أسعارها، وغياب الأثاث التعليمي الآمن. تضيف:
"كان الأطفال يتلّقون دروسهم على رمل الخيمة، لكنني كنت أحاول أن أجعلها مساحة آمنة يتلاقى فيها الطفل أساسيات التعليم" وهي بذلك تحاول أن تعيد بناء قيمة الانضباط الذي باتت مفقودة في الحرب ولا يحققها سوى نظام المدرسة.
بدأت المبادرة بعشرة طلاب من أبناء إخوتها، وانتهت بحوالي 50 طالب من المنطقة المحيطة، واعتُمِدت كنقطة تعليمية من خلال الوزارة بعد ستة أشهر عمل متواصل منها ومن الفريق البسيط الذي كوّنته فقط. كان الدافع إعادة تأسيس الأساسيات التعليمية التي يحتاجها الفرد فيما بعد، الآن وبعد أن عادت نادية إلى مدينة غزة أعادت معها تفعيل مبادرتها وتستقبل في منزلها في ذات الغرفة التي حاولت ترميمها واصلاحها 30 طالب يومياً موزعين على الصفوف الأساسية الأولى يتلقون المواد الأساسية وتسعى لأن تظل هذه المبادرة وتتوسع.
هذه المبادرة وغيرها تُعيد شحن رمزية "العلم كخيار وجودي ومقاومة رمزية" للحفاظ على ما تبقى فينا رغم عجز الفرد الطالب عن الرغبة بمواصلة الأمر في ظلّ اعتبار التعليم مجرد رفاهية حيث تتوحش الأساسيات وتغيب عن يومياته ويصير مصير الفرد مرهونًا بالبحث عمّا يمنع الخوف ويأتي بالأمن، ويسدّ الجوع.
في أيام نزوحي بمدينة دير البلح، تعرَّفت إلى الشقيقات الثلاث جارات النزوح ويسكُنَّ الحي الذي نزحت فيه، اضطررن إلى افتتاح مساحة خاصة ببيتهن وتقديم الخدمة التعليمية مقابل رسوم رمزية. الشقيقات الثلاث هن حاصلات على شهادات في التربية والآداب لم يحظين بفرصة الوظيفة فاستثمرن جهودهن تلك بإنشاء هذه المساحة التعليمية، أخبرتني إحداهن وقتها:
"نحن لا نمتلك إلا البيت، وشهاداتنا وليس لدينا أيّ وسيلة دخل تُساعدنا في هذه الأيام الصعبة، كنّا نظن في البداية أنَّ الأهالي لن يتقبلوا إرسال أطفالهم إلى مساحة تعليمية يدفعون فيها مبلغاً" المبلغ الذي يُدفَع للشقيقات كان لا يتجاوز 3 شيكل أيّ دولار واحد فقط، وهو ما كان يُشكِّل هاجساً لديهن في ظلّ الظروف الصعبة التي يواجهها الناس من نزوح وغيرها من ظروف اقتصادية صعبة؛ لكنها كما تقول :"فوجئنا بهذا الإقبال من الأطفال ومن الأهالي وحرصهم على التواصل معنا لتطوير قدرات أطفالهم، فعلى الرغم من غياب الانترنت إلا أنّ الكثير من الأمهات كانت تتواصل معنا عبر الواتساب لتعرف كيف تُواصل دورنا التعليمي مع ابنها في الخيمة".
ربما كانت الخيمة بالنسبة للشقيقات الثلاث مجرد فكرة لكن مع مرور الوقت صارت هذه الخيمة التي وُضِعت في ساحة البيت مصدر دخل بسيط، وبالتالي فإنَّ هذه المبادرات تُساهم في سدّ فجوات أخرى في حياة النساء المعلمات خاصّة، وهي بذلك تعكس الوجه الآخر للحياة في غزة، الحياة اليومية التي تُصرّ على البقاء رغم الموت اليومي.
لكن يبقى السؤال هل تُمثل مثل هذه المبادرات مُنقذاً حقيقياً؟
تبقى هذه المبادرات في إطار الجهود الذاتية التي تمتد جذورها من الانتفاضة الأولى في مواجهة عرقلة مسيرة العملية التعليمية؛ مما يجعل التعليم يشكل رُكناً أساسياً في الهوية الفلسطينية وليس مجرد فرصة لكسب العيش وذلك لا يُشكِّل عيباً في تاريخ الظروف الاستثنائية التي تعيشها غزة الآن، لكن من الواضح أنَّ هذه المبادرات لا تحلّ محلّ التعليم الرسمي؛ ولكنّها قد تسدّ فجوة صغيرة. فهي لا تُقدِّم قيمة الانضباط المُطلقة التي تؤسسها المدرسة قبل التعليم، في ظلّ اعتمادها على الموارد الذاتية وغياب المتابعة والرصدّ الحقيقي للنتائج والذي قد يعرض بعض هذه المبادرات للاعتماد على الارتجال بالإضافة إلى أنَّ الكثير من الأماكن ذاتها غير آمن صحيَّاً بنسبةٍ كبيرة، رغم حرص المبادرات على هذا الأمر، عدا عن الضغوط التي تُواجهها المعلمة بشكلٍ خاص من تحدّيات بإزدواجية الدور وهي أن تقوم بدور المُربية والمرشدة النفسية في ظلّ تصاعد حالات الخوف والصدَمات بين الطلاب وعليها الموازنة بين الدورين، وهذا ما يُؤكد فعل الارتجال في ظلّ عدم تمكنّها للإسعاف أو العلاج النفسي.
ولعلّ أهم ما كشفته هذه المبادرات الفردية الذاتية هو غياب كامل لخطط الطوارئ الواقعية التي يسهل تفعيلها بسرعة بالإضافة إلى الانقسام بالقرار الرسمي الفلسطيني الذي ساهم في تعميق حالة الفجوة من استمرار العملية التعليمية في محافظات الوطن وتعطّلها في غزة. فبالتالي لم يكن أمام المجتمع إلا البحث عن حلول ذاتية لا يمكن إنكارها، وهي بحاجة ألا تُنسى أو تُهمَش وأن يكون الهدف الأساسي لإعمار العملية التعليمية ليس بناء المدارس فقط، بل تمكين من حَمل التعليم على عاتقه في قلب الدمار وكتب على سبورة متهالكة في بيت أو خيمة:
"الحرية أجمل" !

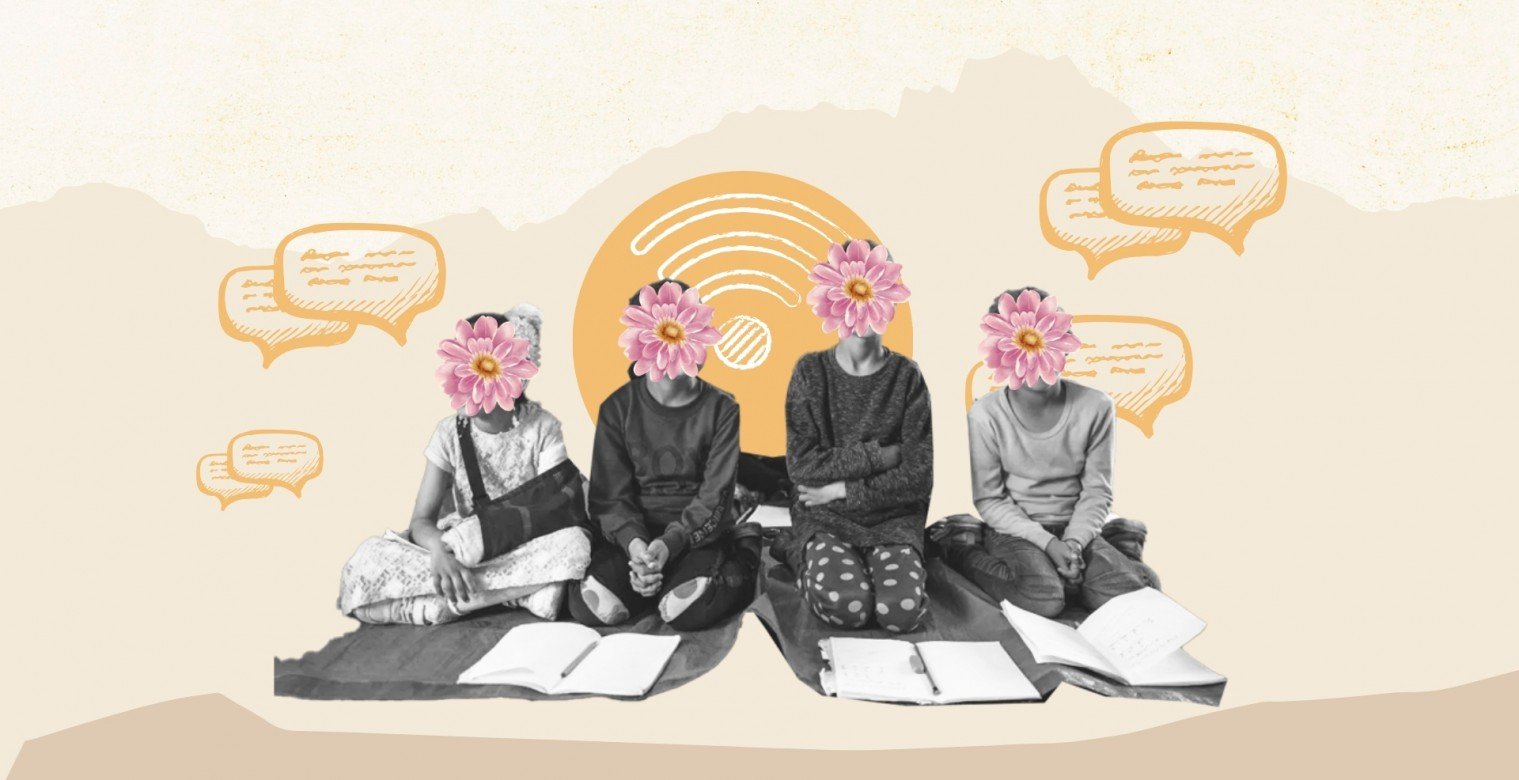

المبادرات التعليمية في قطاع غزة